يوماً بعد يوم يتأكد لي أن هناك أزمة في فهم بعض المسلمين لما يمكن أن يسمى ب "مراد الله" من العباد. وطلبة العلم الذين يعرفون ظاهراً من العلم كثيرون، ومع انتشار الإنترنت أصبحوا أكثر اطلاعاً على بعض الكتب القديمة، ولكنهم أصبحوا أقل وعياً بما فيها، وأقل فهماً لمحتواها ومضمونها.
وأخشى أنه مع انتشار هذه الظاهرة وغياب الوعي والتوجيه من العلماء الربانيين أن يتم اختراع دين جديد مشوه يختزل الدين في بعض المظاهر والطقوس، ويركز على السلوكيات الفردية من قبيل افعل ولا تفعل، مهملاً المفاهيم والقيم الأصيلة التي ينبغي أن تكون المحرك الأساسي وراء السلوك، لا أن تكون التفسير الملحق به والمبرر له.
ليست لدينا أزمة في الصحفيين ولا في المصحفيين فما أكثرهم، ولكن لدينا أزمة ونقصاً حاداً في العلماء الربانيين (الذين يعرفون مراد الله ويلتزمون به) الحقيقيين.
ولا أدري كيف يكون العالم عالماً وهو لا يعرف شيئاً عن عصره، مم يتشكل ولا كيف يتطور، ولا ما عمت به البلوى.
وكيف يكون العالم عالماً وهو لا يعرف شيئاً عن فقه النوازل، وفقه المالآت وفقه المقاصد وفقه الموازنات والترجيح؟
كيف يكون العالم عالماً وهو لم يقرأ شيئاً عن موجبات تغير الفتوى في العصر الحديث؟
كيف يكون العالم عالماً وهو يردد في فتاويه آراء تعود لعلماء أجلاء عاشوا في عصر التتار والحروب الصليبية حيث كان الخلفاء المستضعفين يطلبون من القساوسة أن يصلوا صلاة الاستسقاء، وحيث حكم النصارى في الفروج وغالوا في البغال وفي السروج (كما يقول الشاعر الخلال) فأراد العلماء الغيورون كف كيدهم فكان منهم التشديد في النهي عن التقرب للنصارى ومجالستهم ومشاركتهم احتفالاتهم المشبوهة.
كيف يكون العالم عالماً، وعلاقته باللغة لا تتجاوز قراءة الصحف السيارة، فلا يعرف الفرق بين البر والإحسان والمودة والموالاة. واللغة العربية لا تكفي وحدها في فهم المراد ولا بيان الدليل، فاللغة مثلاً في صيغة الأمر مثل: "اكتب" لا تستطيع أن تحدد هل هذه الصيغة للأمر أم للاستحباب أو للإرشاد أم للتوجيه أم للنصيحة أم للإباحة بعد حظر أم لمطلق العفو… و كلمة "اصطادوا" في قوله تعالى: "فإذا حللتم فاصطادوا" هي للإباحة، وهي مختلفة تماماً عن "فافسحوا" في قوله تعالى: "وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا" التي تفيد الاستحباب، وهي بالتأكيد مختلفة عن قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" التي تفيد الوجوب.
وعلى العالم قبل أن يفتي أن يتبين إذا كان دليله هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول أحد صحابته، ولا يتبرع بترديد أن قول الصحابي هو حديث مرفوع بغير ضوابط. هل يبذل العالم ما يكفي ليدرس هل جاء هذا القول في سياق الحكم الشرعي أم الفتوى أم القضاء أم الرأي الشخصي؟ ومن ذلك مثلاً كما يقول الإمام القرافي: فإن طريقة جمع وصرف أموال بيت المال وقسمة الغنائم وعقد العهود للكفار ذمة وصلحاً هو من شأن الخليفة والإمام الأعظم، ولا علاقة لها بالتشريع. واختلف العلماء في توصيفهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند بنت سفيان: "خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف" هل هو حكم شرعي يصلح لكل أحد أن ينفذه، أم هو قضاء قضى به القاضي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فلا يحق تنفيذه إلا بقضاء ومعرفة الملابسات، وعندها يمكن أن يقضى بغيره، ولو خالف الحديث المروي.
إن فقه الدليل مطلوب ومشروع، ولكنه ليس متاحاً إلا لفطاحل العلماء ممن يعرفون مع مظان الدليل مدلولات اللغة وأصول الفقه والناسخ والمنسوخ وأحاديث الباب والتاريخ وجملة من العلوم والمعارف لا يستطيعها اليوم إلا قلة معدودة على أصابع اليدين، ولا يكفي فيها التقوى والورع واتباع الهدي النبوي في السمت والمظهر.
وقد اختلف العلماء كذلك في الاحتجاج بقول الصحابي على مذاهب شتى، فمنهم من اعتبره حجة وقدمه على القياس، ومنهم من لم يعتبره حجة وهو قول للحنابلة، ومنهم من فرق حسب موضوع القول، فإن كان رأياً لم يحتج به، وإن كان في الأحكام اعتبره في حكم المرفوع، واختلاف الصحابة في أحكامهم مشهور وتمتليء به كتب الفقه، ويمكن الاستئناس به إذا وافق روايات أخرى، أما إذا كان متفرداً ولم يرد بالتواتر فالأرجح التوقف فيه، خاصة إذا كان مخالفاً لمجمل الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب.
ولا يمكن لعالم مهما ذاع صيته وعلا شأنه كداعية وخطيب أن ينسب إلى العلماء المجتهدين، وهو لم يدرس كيف تتغير الفتوى بتغير المكان والزمان والحال والعرف، بل وأضاف إليها العلامة المجتهد الشيخ القرضاوي :تغير المعلومات، و تغير حاجات الناس، وتغير قدرات الناس وإمكاناتهم، و تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعموم البلوى، و تغير الرأي والفكر.
وفي كتب الفقه عشرات الأمثلة على كيفية مراعاة العلماء لهذه الضوابط في فهمهم لمراد الله وتحقيقهم لمناط الأدلة. وقد كان العلماء قديماً لا يأخذون بشهادة حاسر الرأس أو حليق اللحية أو من يأكل "السندوتش" باعتبار أن هذا من خوارم المروءة، ولو طبق هذا الرأي الفقهي الآن لخلت المحاكم من الشهود، فهذا مما عمت به البلوى.
وفي كتب الفقه عدم قبول شهادة البدوي على الحضري لأنه غير عالم بحياة الحضري ولا نمط عيشه ولا مصطلحاته، بل وعندهم النهي عند إمامة البدوي للحضري لأن الغالب أن الحضري أعرف بالأحكام وأشهد للجمع والصلوات في المساجد. وأجاز العلماء لأهل الإسكيمو التيمم بالثلج لانعدام الصعيد الطاهر، واقتناء الكلاب لعدم قدرتهم على الاستغناء عنها في حياتهم اليومية.
ومما ذكره الفقهاء في ذلك: أن الإمام ابن أبي زيد القيرواني صاحب (الرسالة) المعروفة في المذهبالمالكي، والتي شرحها كثيرون. هذا الإمام زاره بعض معاصريه من الفقهاء، فوجدوا في داره كلبا للحراسة. فقالوا له: إن مالكًا رضي الله عنه كان يكره اقتناء الكلاب. فقال لهم: لو أدرك مالك زمننا لاتخذ أسدًا ضاريًا.
والعُرف في الشرع له اعتبار……… لذا عليه الحكم قد يدار
يقول الإمام القرافي: "إن استمرار الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد: خلافُ الإجماع وجهالةٌ في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد".
ويقول أيضا: "فمهما تجدد من العُرف اعتبرْه، ومهاما سقط أَسقطْه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك، لا تجبره على عُرف بلدك، واسأله عن عُرف بلده، وأجره عليه، وأفته به، دون عُرف بلدك، والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين، والسلف الماضين"
ولو تمسكنا بظاهر النصوص وحدها لحرمنا التعامل بالشيكات المصرفية، فلو اعتبرنا القبض كما قرره الفقهاء (يدا بيد، أو هاء وهاء) لما انطبق ذلك على الشيكات، لأن القابض لا يصرف المبلغ في مجلس العقد وإنما بعده. ولحرمنا البيع عن طريق الهاتف أو الإنترنت لعدم حضور البائعين مجلس العقد.
وحتى الصحابة كانوا يفتون بشيء ثم يغيرون رأيهم إذا ثبت لهم خطؤهم، ومن ذلك مسألة الميراث المشهورة باسم المسألة الحمارية للفاروق عمر بن الخطاب، ولم يجد الفاروق بأساً من تغيير اسم الجزية على نصارى تغلب إلى صدقة لأن العبرة بالمضامين لا بالمسميات، وكذلك يتغير رأي العلماء إذا تغيرت المعلومات المتاحة، من ذلك مثل قول بعض العلماء المعاصرين بتحريم ختان الإناث بعد ما تواتر من الأطباء عن أضراره مما لم يكن معروفاً من قبل. ومنه تغير رأي علماء السعودية في الرمي قبل الزوال، وعدم المبيت بمزدلفة، والسماح بصكوك الأضحية بدل أن يمارس الحاج الذبح بنفسه، وطواف الحائض تخشى فوات الرفقة، وتغيير ضوابط تحريم الاختلاط، وغيرها كثير. ولا بأس أن يتغير ذلك في المستقبل فيعود الرأي القديم للتطبيق إذا ثبتت معه المصلحة.
…………….
والخلاصة…
أننا في حاجة إلى علماء واقعيين يتنفسون عصرهم، علماء يستوعبون معنى أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وما تعنيه هذه المقولة من وجوب فهم النصوص والتعامل معها بما لا يهمل مقتضيات العصر – دون أن يعني هذا بالضرورة التوافق معها– ويحسنون اختبار مقولة بعض المثاليين من الأصوليين من أن الإسلام – بحسب فهمهم له – يُصلِح كل زمان ومكان.
والمقولة صحيحة فيذاتها، غير أن فهم بعض المسلمين للإسلام بما يحصره في مجموعة من الطقوس والشكليات،وإجبار الناس على الالتزام بها – لإصلاحهم وهدايتهم- لا يتفق مع ما يَصلُح للناس فضلاً عن أن يُصلِحهم.
وباختصار – أرجو ألا يكون مخلاً- أرى أننا في حاجة إلى خطاب دعوي فقهي مشترك يقود الصحوة الإسلامية الراشدة، وبحيث يكون محصلة القراءة الرشيدة لثلاثة عناصر بنفس القدر والاهتمام:
أولها: النصوص الشرعية من قرآن وسنة، ومن خلالها نفهم التوجهات القرآنية العامة، والمقاصد الشرعية الكلية، وحدود الحركة في القبول والرفض. ومن خلال هذه القراءة وهذا الفهم، يتكون لدى الباحث خط عام يجب أن يكون متسقاً في القضية محل الدراسة مع الخط العام للدين الإسلامي.
بمعنى أنه إذا ثبت من تتابع النصوص أن الخط العام للإسلام مثلاً: هو قبول الآخر واحترام أسباب اختلافه، فإنه لا يكون مقبولاً أي فهم –لأي نص- يستنتج منه مفسره أن الإسلام يحل ترويع غير المسلمين والتنكيل بهم، فضلاًعن الاستعلاء والتضييق عليهم في التعامل اليومي.
وثانيها: تاريخ تعامل وتفاعل المسلمين مع هذه النصوص، وأشكال ممارستهم و تطبيقهم لها،ومدى اقتراب أو ابتعاد هذه الممارسة من الخط العام. وعلاقة هذه الممارسة – التي تختلف باختلاف العصر- بحال الأمة قوة وضعفاً.
وهذه القراءة التاريخية تفيدنا في فهم النصوص، دون أن تكون تفسيراً لها. وعلى سبيل المثال فإن أفضل تفسير لقوله تعالى: "يدنين عليهن من جلابيبهن" لن نجده فقط في كتب الدين والفقه وحدها، وإنما أيضاً في كتب التاريخ والأدب حيث نعرف كيف طبق المسلمون الأوائل هذا الأمر ومارسوه.
والقصد أنه مما يعيننا على فهم مراد الله كما جاء في النصوص هو أن نتحقق مما يلي: إذا حاز أحد أشكال التطبيق قبولاً من المعنيين بالشأن الديني في عصرمن العصور، فإن هذا الشكل حجة على فهم النص، وإذا حاز شكل آخر من التطبيقات اعتراضاً عاماً من المعنيين بالشأن الديني في عصر التطبيق، كان هذا حجة على فهم ظروف العصر.
وثالثها: واقع الأمة السياسي الحاضر،
ومركزها العالمي قوة وضعفاً. وتقدير اختلاف ظروف المسلمين في المكان – أغلبية أو أقلية – كما قدرنا اختلاف ظروفهم في الزمان، وتقدير الواقع السياسي الذي يسمح بقبول سياسي للمرفوض – أو خلاف الأولى – الديني. ومثالي هنا هو نصوص "الجزية" و "الرق" و "الحدود".
ولا يجرؤ أحد على إنكارالنصوص، ولا فرصة له في تأويلها مع وجود تاريخ واضح من التطبيق، غير أن الواقع السياسي الذي لا يسمح بتطبيقها لا ينبغي أن يؤخذ حجة للانقلاب على الحكام و زرع الفتنة بين الشعوب.
والرسول (ص) نفسه على ما له من مكانة روحية غير مسبوقة لزعيم بين أتباعه، وبعد النصر الساحق في فتح مكة، وجد أنه من غير المناسب "هدم" الجزء الزائد من الكعبة لإعادتها إلى قواعد إبراهيم عليه السلام، وقال للسيدة عائشة مبرراً "إن قومك حديثو عهد بجاهلية"، وتأخر تنفيذ هذا التصحيح إلى ما بعد رحليه بعشرات السنين.
وأية محاولة لطرح خطاب رشيد بإهمال أحد أضلاع هذاالمثلث محكوم عليها بالفشل. وهذا هو السبب في ما نجده من اختلاف ضخم في هذه الأطروحات، بين سلفيين يقرؤون النصوص وحدها، وأصوليين يريدون استنساخ فترات من تاريخ المسلمين والعيش فيها كما هي، وعلمانيين منسحقين أمام الغرب بسبب تردينا السياسي والاقتصادي والثقافي.
وفي هذا الإطار فإن:
"المأمول دينا" وهو ماتعرضه النصوص باعتباره المثال الأعلى في المدينة الفاضلة، قد يختلف مع "المحقق تاريخياً" والذي حاز قبولاً عاماً من المعنيين بالشأن الديني في حينه، وحتى هذا قد يمثل سقفاً أعلى من "المتاح واقعياً"، والذي هو حصيلة جهود جماعات وقوى سياسية واجتماعية متنوعة، وبعض هذه القوى يعادي الدين وبعضها يعمل على إقصائه.
ويظل معيار النجاح في طرح خطاب إسلامي رشيد هو جعل "النص الديني" ملهماً لاتخاذ المواقف المعضدة لتحقيق المصلحة العليا للأمة، و قراءة "التطبيق التاريخي" باعتباره مرشداً لأفق التحقيق وحدوده الدنيا، و التعامل مع "الواقع السياسي والاجتماعي" باعتباره مسرح الأحداث، ومعمل التجارب، وموضع الامتحان. وفيه تظهر النتيجة، فيكافأ المجتهد بعمله، أما المسرف المهمل المفرط في دينه وتراثه وتاريخه فليس له إلا أن يهان.
……….
والله تعالى أعلى وأعلم.
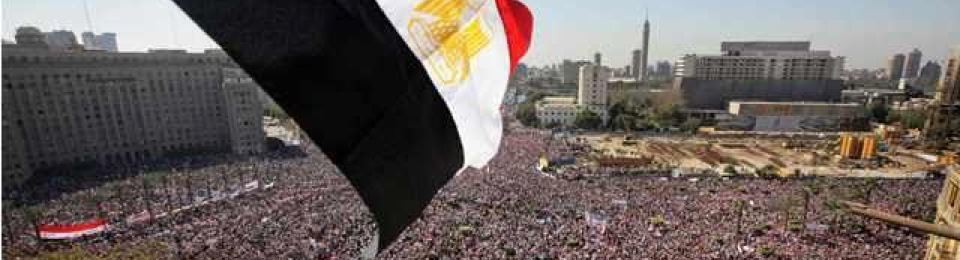
قراءة عميقة ..لواقع أليم .
……..
تحيّاتى الدائمة .